مع صلاة عصر يوم عرفة والإعلان عن الحضور الصيفي لعيد الأضحى، تدلّت تكبيرات العيد من مآذن حلب حاملة معها ما يتوغل في النفوس من سكينة، رائحة الخراف، حزن اليتامى، أمل المتعبين ببطون ممتلئة يزورها اللحم مرة كل عام، بعد أن بنت العناكب بيوتها على أبواب “القصابين” وبطون السكان الخاوية.
أصوات الباعة والأضواء الملونة والبضائع المكدسة لخصت ليل وقفة العيد في حلب، صوتهم، أي الباعة، يتواتر في الارتفاع مع مرور المشاهدين لا الزبائن، محاولين جذب انتباه الصغار للضغط على أهاليهم، لا يمكن أن تجبر “جيباً فارغاً” على المتعة، لسان حال من تحدثت معهم لأشاركهم ما يدور في ذهني، اكتفينا بعدها بالصمت.
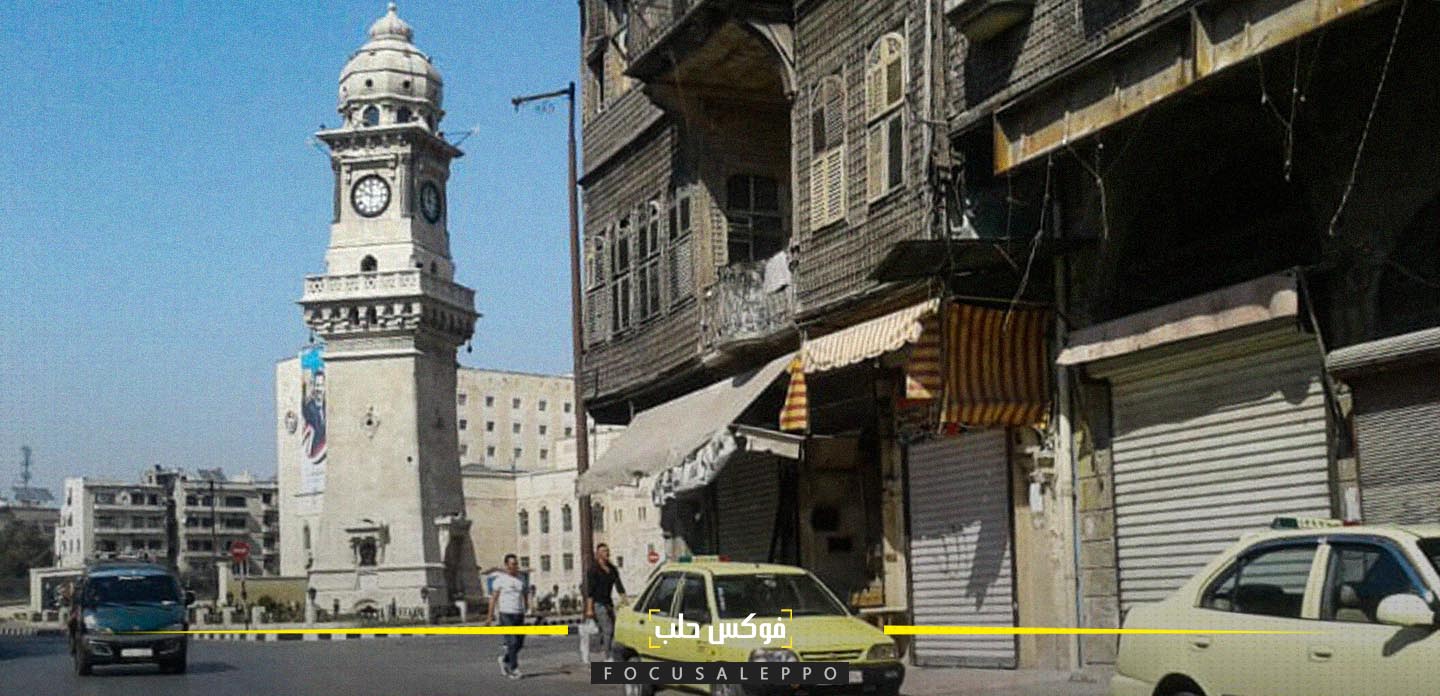
لم تحضر أغان العيد في ذاكرتي، واحدة منها فقط تشبثت بلساني، صوت أم كلثوم “الليلة عيد.. عالدنيا سعيد”، وبت أكررها لأؤكد فكرة وجود العيد المحتمل بعد أن تسلل الجدب إلى كل شيء، حتى إلى الأغاني!
هل يمكن أن يسقط العيد من السماء، مثل غيمة، وكيف يمكن أن نفسر هذا البرود تجاه كل شيء؟
تنتظر طفلتي العيد على الباب منذ أخبرتها مجازاً “إجا العيد”، فتحت النافذة والأبواب مرات عديدة لتؤكد أن لا أحد مرّ من هنا وطرق أبوابنا، أمام حيرتها أخبرتها أنه يدخل عبر القلوب لا الأبواب.
لم يحضر العيد بشكله الجسدي كما يفعل (بابا نويل)، ولا بروحه كما كان يدخل الأرواح فيما مضى عبر لمة الأهل والأحباب، والأصحاب، والثياب الجديدة، والأطعمة المتنوعة، وعبر زيارة المقابر بعد صلاة العيد، ومن خلال الأراجيح وألعاب الأطفال.
في ليلة العيد هذه، عرفت للمرة الأولى أن أم كلثوم ماتت بحق!
الأعياد ليست للموتى
لا يستطيع الموتى زيارة بعضهم البعض، ولا زيارة الأحياء إلا عبر رؤى بيضاء، أو صورة خليوية، أو قرص مدمج يدور في الذاكرة البعيدة.
زيارات الأحياء بدأت في الآونة الأخيرة تأخذ طابع الموتى، تبدو المسافات بعيدة بين الأحياء المحيطين بنا والقريبين منا مكانياً، أكثر من الأموات الذي يمضون موتهم الدنيوي متلاصقين، ملتزمين بأماكنهم المخصصة، يناقشون الوقت البطيء، وموعداً سوف يأتي لا محالة، من أجل الانتقال إلى مثوى الروح الأخير بكل ذراتهم، وأعمالهم الدنيوية.
قطيعة فرضتها الحياة، والظروف، وصعوبة الموت، في بلد نصب فيه ملك الموت خيامه عند المفارق والدروب والقرارات الحكومية المحنطة.
في المقابر كانت الأشباح الحية تبحث عن الأشباح الميتة التي ترسل صورها وذكراها عبر الثرى.
في حالة فائقة من الضياع والاغتراب، تبحث عن موطئ قدم تحت الأرض، بعد أن ترك أهل الأرض أبناء جلدتهم يهيمون على غير هدى في اتجاهات الدنيا كافة، هرباً نحو الحياة ببعض الكرامة.

الأموات بخير، فلا حاجة لسؤالهم عن الأحوال والعمل، يكفيهم دعاء بظهر الغيب، أو فسيلة خضراء تخفف عنهم قيظ الانتظار. لكن الأحياء يمارسون الموت التراكمي بشكل شبه يومي، على الأفران، والمؤسسات التموينية، وصرافة النقود المعطلة، والمشافي التي تعج بالإهمال، ومكاتب الموظفين المتسيبين، حتى يتم الموت عدته ودقائقه وتبدأ عملية الانتقال الرحيمة إلى الحياة الأخرى بكرامة تحت الأرض.
مدن بلا أطفال
تحيا المدن بالأطفال، بضحكاتهم، بشغبهم المتواصل في البيوت والشوارع، هم يجيدون الحياة، ويعرفون جيداً كيف ينعشون المدن بحضورهم الكثيف، وكيف يخلعون الضحكات على شفتيها.
الشوارع خالية إلا من بضعة أولاد يلهون بمسدسات بلاستيكية تطلق الماء، أو الكرات البلاستيكية الصغيرة، كي يفتحوا الأبواب للأدرينالين في أجسادهم البضة، ولكي يشعلوا الشجار والأصوات في مداخل الأبنية.

لم يعد الأطفال يحبون مدن الألعاب واللهو، فلم يعد فيها ما يغريهم ويحفزهم على الهروب إليها، من ملل البيوت والأبنية والشوارع، لقد غيرت الحرب أمزجتهم ورغباتهم، وشيفراتهم الوراثية، وحولتهم لكائنات عنيفة، تصارع الحياة. مثل آبائهم يقفون في الطوابير الكثيرة في زمن لم يعد فيه للطفولة مكان.
كوكب الخرفان

مع الصعود العمودي لأسعار الخراف، والذي تجاوز سعر الكائن البشري بأضعاف كثيرة، أصبحت التضحية بأحد الأولاد من خلال وحي منزل، أو رؤيا إلهية، أو موت متربص، حالة تسيطر على الكثير من السوريين من خلال رمي الأطفال في سوق العمل، ووأد البنات قبل نضجهن في حضن الأزواج ذوي الشعر الأبيض، يضاف إليها الكثير من نكهات الذل والهوان المصنع بأيد وطنية جداً.
شاهدت بالأمس خروفاً يلهو مع أقرانه، في الصيوان المعد لتسمينهم قبل ذبحهم، مثل أي طفل في مدينتي يجهل ما يخبئ له الزمن القادم.

